“شجون الغريبة”.. تحولات قصيدة النثر اليمنية من مجلة شعر إلى صفحات فيسبوك
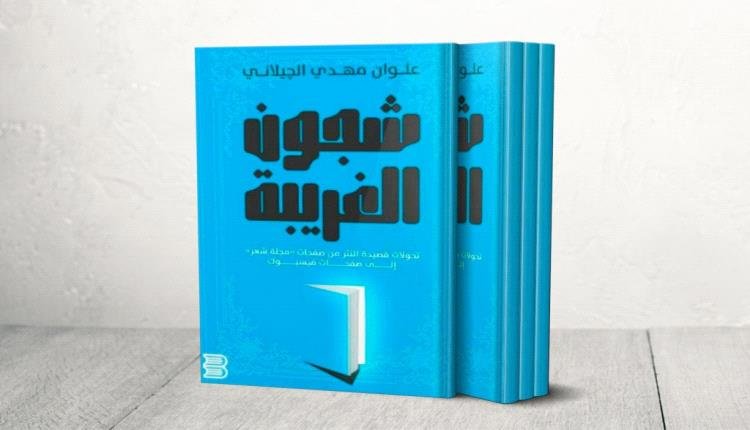
[ad_1]
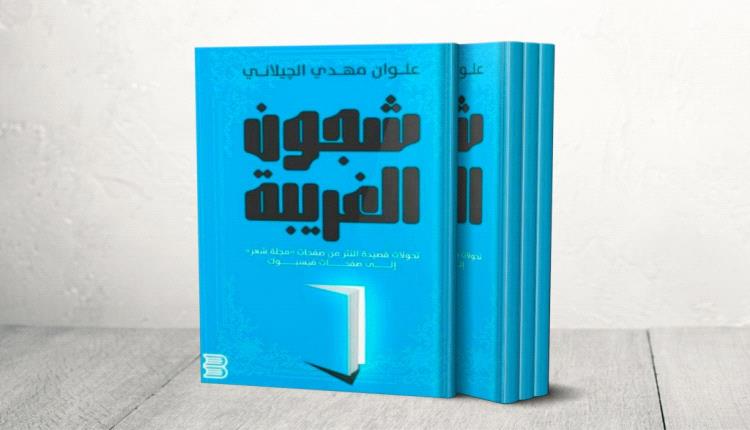
يقدم الكتاب تجربة امتدت سنوات طويلة، عكف المؤلف خلالها على تتبع بدايات قصيدة النثر العربية من خلال نماذجها الأولى كما كتبتها “جماعة مجلة شعر”، ثم من خلال نماذج كتبتها الأجيال التالية لها، مؤشرا إلى سماتها في كل مرحلة مرت بها، وصولا إلى مرحلتها الراهنة، حيث وجدت قصيدة النثر في صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حاضنة استثنائية خلصتها من فوقيتها ونخبويتها الزائدة عن الحد، ومن ثم خلصتها من عزلتها وقلة مقروئيتها، وأسهمت في إثراء عوالمها وتعديد أساليبها وتفضيلاتها.
الكتاب الذي صدر عن دار “عناوين بوكس” في القاهرة، ويقع في 420 صفحة من القطع الكبير، يقدم قراءات واسعة لقصيدة النثر من خلال نماذج لأكثر من 80 شاعرا يتوزعون على سائر الجغرافيات العربية في مشرق العالم العربي ومغربه، ويظهر كثيرا من مفاتيح اشتغالات الكتاب، بدءا من مسوغات تسميته في مقدمة الكتاب، التي تستعرضها مقدمة المؤلف التالية:
“شجون الغريبة”
في منطقة تهامة “غرب اليمن”، حيث ولدتُ، ثمة عرف ثقافي اجتماعي عجيب يعدّ الضيف غريبا، يصف الضيوف بالأغراب، ويستطيع المرء أن يخاطب الضيوف في عرس ابنه مثلا بهذا الشكل: تفضلوا الغداء يا أغراب.
القادم الجديد للسكن في قرية أو دَيْر يحمل صفة الغريب، وقد تظل هذه الصفة تلازمه بقية عمره.
زوجة الابن، إذا كانت من قرية أو دَيْر غير قريته أو دَيْره سوف توصف بالغريبة، ولن تسقط عنها هذه الصفة مطلقا حتى لو تراجعت قوتها الصريحة بتوالي السنين وإنجاب الأبناء: “الغريبة ذهبت، الغريبة جاءت، الغريبة دخلت، الغريبة خرجت، الغريبة حملت، الغريبة ولدت”.
وطوال الوقت سيظل داعي التمييز يحضر بسبب خصومة أو شهادة على خصومة، أو منافسة مع زوجات إخوان الزوج، المنتميات أصلا إلى المكان، سيحضر وصفها بـ”الغريبة”.
هذا جانب من مقصود التسمية ودلالتها، وهو يتكئ على كون حضور قصيدة النثر في المشهد الإبداعي العربي ظل ملتبسا بهذه الدلالة منذ البدء، فقد حضرت كشكل تم استيراده من أدب آخر، من لغة أخرى وثقافة مختلفة، وظل المشهد الثقافي العربي حتى اللحظة يتعامل معها بوصفها غريبة.
وزاد من حديَّة هذا الوصف وتكريس وطأته عليها ارتباط غربتها بغرابة تسميتها “قصيدة النثر”، فلم تكن معاناتها من وصف الغريبة يقتصر على قدومها من ثقافة أخرى، وإنما من غرابة التسمية التي ضاعفت حدة التمييز ضدها، وأشعرت المتلقي العادي بقلق التسمية، بينما هو ينتمي إلى ثقافة راكمت -عبر قرون طويلة- مفهومين واضحين للشعر والنثر.
ولعبت وصايات عديد المنظرين والنقاد على قصيدة النثر دورا مماثلا في تكريس وصفها بالغريبة، فهم لم يكتفوا بجعل قبولها أو ممارسة كتابتها ترتبط ارتباطا شرطيا برفض الأشكال الأخرى فقط، بل بالسخرية من الهيئات الصوتية الإيقاعية للوزن والتشطير، حتى إنهم حوَّلوا ممارسة كتابتها إلى عقيدة لا يكتمل الولاء لها إلا بالبراء من الأشكال الأخرى.
ناهيك عن إصرار أولئك النقاد والمنظِّرين على تسييج محدداتها من خلال بضع سمات تقبَّلتها اجتراحاتها في اللغة الفرنسية مثل: الإيجاز، الكثافة، السردية، واللاغرَضية. متجاوزين أو غير منتبهين إلى أن سمات التعبير تختلف في اللغة التي انتقل إليها الشكل، وأن هناك تضمينات ثقافية لا بد أن تفرضها الحاضنة الجديدة عليه، كما حدث في حالة الشعر الفارسي الذي تأثر بالعَروض العربي، بحورا وأوزانا وقوافي، لكنه أخضعها لتضمينات الثقافة الفارسية في الشكل وفي المضمون، فنتج عن ذلك انزياحات كثيرة، لعل أبرز تجلياتها تنعكس في رباعيات الخيَّام، ومثنوي جلال الدين الرومي.
وحدث ذلك، رغم أن قصيدة النثر العربية قد اكتسبت في واقعها سمات جديدة، وأصرت على ممارسة حريتها في تناقض مفارق مع منظِّريها الذين أدخلوها إلى المشهد الإبداعي العربي بوصفها جزءا من حرية الكتابة التي ينشدونها، ويتخلصون بها من قيود الأشكال الموروثة ومحدداتها.
غير أن ثمة فاعلا لعب الدور الأهم في تكريس وصف الغريبة وعزز انطباقه على قصيدة النثر، ذلك هو ربط ممارسة كتابتها بنخبة فوقية، أعوزتها محددات قصيدة النثر المنقولة حرفيا عن الفرنسية إلى قوة التواصل مع الجمهور، وبدلا من مراجعة قضية التمسُّك الحرفي بالمحددات المنقولة بوصفها سبب سوء الفهم العالق بين قصيدة النثر وجمهور القراء، راحت تلك النخبة تكرِّس عزلة هذا الشكل بمزاعم خرقاء؛ مثل القول، بأنه شكل صامت، وأنه ينكتب للقراءة فقط، وأنه ليس جماهيريا، إلى غير ذلك من المزاعم التي جعلت هذه القصيدة غير قادرة على التخلص من وصف الغريبة.
وكان هناك نوع من الخبث في توجيه هذه المزاعم عبر احتكار منابر نشرها التي تقوم على اصطفاءات لا علاقة لها في الغالب بتحقُّق الشعر في النص، ولكن علاقتها قوية بموجهات “أيديولوجية” وسياسية و”شِلَلية”، وقد بلغ من حدة هذا المنحى أنه كان لا يتورع عن خلق الأعداء لقصيدة النثر حين لا يجدهم.
الأكثر غرابة من ذلك كله أن أكثر المنضوين في هذا التوجه كانوا أقل كُـتَّاب قصيدة النثر إبداعا، وكان يصدق عليهم قول البردوني، “إن الإمكان في الشاعر ذاته، لا في المُنْتَمَى المدرسي؛ لأن المدارس الأدبية وجهات عامة، أما عظمة الشعر فهي تترعرع من إمكانية الشاعر وحده، لذلك سقط عشرات الشعراء، ألهتهم المباراة على الحداثة عن معرفة الإجادة والأصالة”.
والغريب أن اللعبة خدعت زمنا طويلا المشهد الثقافي، ولم يدرك هذا المشهد زيفها إلا عندما كسرت المواقع والمنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي هيمنة النشر المتعالي، وخلال سنوات صارت قصيدة النثر أكثر الأشكال الشعرية شعبية وتقبلا عند الجمهور، فاتسعت سماتها، واتضحت تضميناتها، وتصالح كتَّابها الجدد مع الأشكال الشعرية الأخرى.
ولعل السر في ذلك أن العوالم الرقمية ساعدت بقوة على انتهاك فكرة القداسة التي كانت تتمتع بها قوانين قصيدة النثر، وهي فكرة كانت تُسيِّجُ الشعر بشكل أكثر وضوحا قبل ظهور هذا الشكل الشعري، إذ أنها كانت جزءا من كُنْهِ الشعر المرتبط بالدين من طرف، وبالكهانة من طرف آخر.. انتهاك القداسة -الذي بدأ بظهور قصيدة التفعيلة في أربعينيات القرن العشرين- اكتسب فاعلية أكثر بظهور قصيدة النثر عند نهاية خمسينيات القرن نفسه، لكنه بلغ ذروته بظهور المنصات الرقمية، حيث جعلت تلك المنصات من النص الشعري لعبة يمكن تداولها بين العامة، بل يمكن كشفها والعبث بقوانينها.
وصار أي نقد رافض يوجه إلى نص ما غالبا ما يُقابل بردَّات فعل سريعة تسوّغ النص المنقود، إما بتأكيد شعريته المختلفة، وإما بجعله كتابة شخصية تقع في مدار الشعر لكنها لا تتقصَّده.
سرعة قبول النص عند المتلقي، وكثيرا ما يكون هذا المتلقي قارئا محايدا، هي ما أرغم المشتغلين بالوصاية على الشعر كتابة ونقدا على رَقْم وثيقة الاعتراف به. وهكذا يمكن وصف مرحلة “قصيدة النثر الفيسبوكية” بمرحلة “الشعر خارج النخبة”، وذلك يعني أن قصيدة النثر اكتسبت في صفحات الفيسبوك ممكنات لم تكن متاحة لها من قبل، وهي ممكنات تتلخص في قدرتها على اكتشاف أسرار القبول عند القارئ.
بتعبير آخر، ذلك يعني أنها نجحت في إلغاء سمات الفوقية والنخبوية والترفع عن هموم الناس، وهي السمات التي كان المتلقي العادي يعدّها وصمة لها.
ما تتمتع به قصيدة النثر الفيسبوكية من ديناميكية، اليوم، إنما ينبع من الطريقة التي تمارس بها لعبة انكتابها، إذ هي تنجح في اقتناص ممكنات طالما كانت خارج الشعر، مثلا “استعارت من كاميرا الهاتف المحمول فكرة الـ”سيلفي selfie”، أو ما يُعرف بالصورة الملتقطة ذاتيا.
ولأن طبيعة الشعر تشتغل على فكرة وجود الكائن داخل العالم، فإن النص برمج نفسه ليأخذ صورة لوجود الكائن، ليس بمعنى عالمه الخارجي، وإنما بمعنى وجوده، حسب اصطلاحات الفلسفة.
إنها صورة لرعبه وقلقه ودهشته وسؤاله وتشكُّكه، ملتقطة ذاتيا، صورة تُطبع بالكلمات، ولم تعد فكرة القياسات الجمالية القديمة تشتغل معها، فهي في النهاية صورة للإبلاغ عن الوجود في مكان ما فقط، قد يكون مكان السؤال أو مكان القلق أو مكان الدهشة.
كذلك هي ترتبط بجملة من السمات الناتجة عن التحامها بالفضاء الافتراضي، أهمها اختلال مُسلَّمة الزمن، إما عن طريق الاستبدال، وإما عن طريق الاستدارة.
ولعل أكثر ما يلفتنا في قصيدة النثر الفيسبوكية هو أنها بحكم نشرها حالات كانت أكثر امتلاكا لإمكانية تقديم نفسها بوصفها محايثا لحياتنا اليومية، وقد نجحت نجاحا عظيما في تحويل الشخصي واليومي والعادي والمألوف إلى سرديات كبرى، وهي من خلال بعض تجلياتها المتمثلة على وجه الخصوص في نصوص مجادلة الحب، ونصوص الاعترافات، ونصوص المخاوف، ونصوص الشكوى، ونصوص الرفض والتهكم، والنصوص السِّيريَّة، تتحول إلى جواذب للمتلقي تفعل به الأفاعيل، فهي تلامسه بسهولة، بينما يصل هو إليها دون أن يصطدم بحواجز تتعالى عليه، أو تتحمَّل بمحمولات أكبر من وعيه.
لهذه الأسباب تغيَّر واقع قصيدة النثر، لم يبقَ من وصف الغريبة إلا المفهوم المتداول في مقاربات الدارسين لها. هنا أجدني أميل إلى القول، إن قصيدة النثر كانت تنتظر صيغتها بقدر ما كانت تنتظر آليات توصيلها.
“الثمرة المحرمة”
في هذا السياق، عليَّ أن أعترف أني حين اقترحت “شجون الغريبة” عنوانا مؤقتا لهذا الكتاب، قبل سنوات، لم أكن حينها قد أنجزت حتى ربع محتواه. كنت أفكر أن المتربصين قد يؤوِّلون العنوان كونه عنوانا مبطَّنا بموقف ضدِّيّ. يومها سطَّرتُ ما أوردته في بداية هذا التقديم عن مفهوم الغريبة والغريب والأغراب في تهامة، بوصفه مسوغا كافيا لتوضيح البعد الدلالي من جهة، وإبعاد تهمة إضمار الرفض عني من جهة أخرى.
لكن استقصاء المؤلفات التي تموضعت قصيدة النثر من أجل الاسترشاد بها، أو التمرجع فيها أثناء إنجاز بقية مقاربات الكتاب، كشفت لي أن مرادفات الوصف الذي اختاره عنواني حاضرة في عناوين مؤلفات ودراسات كثيرة، وأن هناك مجموعة من النقاد تتباين مواقفهم من قصيدة النثر تحيُّزا وحماسة لها، أو رفضا قاطعا لوجودها، أو توسطا وتوازنا تجاهها. لكنها تلتقي في التفكير فيها تفكيرا لا يخلو من هذا البعد الدلالي.
“الثمرة المحرمة”.. هكذا سمَّى الناقد حاتم الصكر أحد كتبه التي تتموضع قصيدة النثر تنظيرا وتطبيقات على النصوص، وقال متحدثا عن هذا العنوان في إحدى شهاداته “عبَّرتُ فيه بمجازفة استعارية عن اعتقادي بأن قصيدة النثر ظلت الثمرة المحرمة في شجرة الشعر”.
مقابل الصكر-المعروف بحماسه البالغ لقصيدة النثر تنظيرا ونقدا وتبنِّيا لتجارب كُتَّابها- نجد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وهو أشهر المناوئين لها يسميها “القصيدة الخرساء”، وهذا عنوان كتاب موضوعه قصيدة النثر أصدره في 2008م.
ودلالة عنوان أحمد عبد المعطي لا تحكم على قصيدة النثر بوصف الغريبة فحسب، بل تقطع بعدم القدرة على التواصل معها، ليس لعدم الرغبة في التواصل معها، بل لعيب فيها هو عدم قدرتها على النطق.
وبالطبع فإنه لا يخفي عداءه السافر لقصيدة النثر، ووصفه لها بـ”الخرساء” يحيل إلى رفضه لتخلصها من الوزن والقافية والإيقاع، واعتقاده بعدم صوابية كونها شعرا، وكون هذا غريبا على مفهوم الشعر في ثقافتنا.
وصفُ قصيدة النثر بالغريبة يتضمنه العنوان الذي اختاره الناقد العراقي علي داخل فرج لكتابه “محاكمة الخنثى”، وهو عنوان مشفوع بعنوان رديف توضيحي “قصيدة النثر في الخطاب النقدي العراقي”.
لكن ما يتضمنه هذا العنوان يشير إلى غرابة التجنيس والمصطلح، حيث تجمع التسمية في ظاهرها بين نقيضين، الشعر مقابل النثر، ومن هنا جاء وصف هذا الشكل الشعري بالخنثى، والوصف يحمل دلالة سلبية تحيل إلى مفهوم “المُشْكِل”، وهو من لا تتبيَّن فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، أو تعارضت فيه علاماتهما حتى أشْكَلَ أمره فلا يُعلم أهو ذكر أم أنثى.
وبالطبع فإن مؤلف الكتاب قد اختار عنوانه للإثارة، أما محتوى الكتاب فهو يتميز بالحيادية والجدية، وهو يأخذ على المتجادلين حول إشكاليتَي التجنيس والمصطلح انحيازهم الضمني لوصف الخنثى، بدلاً من تلطيف الأمر بالقول، إن هذا الشكل -سواء في مصدره الأول فرنسا أو بعد نقله إلى العربية- قد تخلَّق نتيجة انفتاح الأجناس الأدبية على بعضها، وإلغاء الحدود والفواصل الموروثة بين الأشكال التقليدية، بقدر ما هو تمرد وكتابة أكثر حرية.
وقد فضلتُ عدم الخوض في إشكالية التسمية، لقناعتي ألا جديد يمكن أن أخرج به، فقد خاض فيها عشرات وربما مئات من الشعراء والنقاد والأكاديميين، وتكررت حولها الاعتراضات والتحفظات نفسها. مع ذلك فقد شاعت التسمية، وأخفقت مقترحات استبدالها الواحد تلو الآخر، ولم تعُد ثمة جدوى من الخوض فيها.
أصوات متجاورة
فكرة هذا الكتاب تأسست في كتاب “أصوات متجاورة” الصادر في 2010، وهو الكتاب الذي رصدتُ فيه وجوه تجلي جيل الشعراء التسعينيين في اليمن، وسمات منجزهم الشعري، إضافة إلى اجتراح قراءات موسعة لبعض التجارب الفردية المائزة فيه.
وفي العام نفسه 2010 بدأتُ الاشتغال على كتاب “شجون الغريبة”، وخلال 13 سنة لم أتوقف عن المعايشات والمعاينات، والمرافقة، والمراقبة المستمرة لتجليات قصيدة النثر، وما طرأ عليها من تحولات، خاصة بعد ظهور الشبكة الرقمية بمنتدياتها ومواقعها ومدوناتها، منذ مطلع العقد الأول للقرن 21، ومن ثم ظهور مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” و”واتساب”، حيث أثرت تلك المواقع “موقع فيسبوك على وجه الخصوص” بشكل كبير في النصوص لغة وأساليب وفنيات ومحاميل دلالية.
وقد حاولت في هذه الاشتغالات تتبُّع هواجس الإرهاصات الأولى المبشرة بظهور قصيدة النثر، من خلال تتبُّع تبدلات النسق المعرفي وأثرها في النوع الشعري، ومن ثمَّ تتبُّع مراحل تجليها من لحظة استنساخ النموذج الغربي، عند غروب خمسينيات القرن العشرين، وحتى بوادر التضمينات التي ألحقتها الهوامش الجغرافية العربية بها، ثم وضوح تلك التضمينات بجلاء عند مفترق نهاية القرن 20، وبزوغ القرن 21.
بعد ذلك تتبَّعتُ تأثير ظهور الشبكة العنكبوتية وما انعكس منها على قصيدة النثر، حيث بلغ الأثر ذروته عندما بدَّلَت كثيرا من سماتها، وأعلنَت شعبويتها بشكل جارف على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان عليَّ وأنا أتتبَّع ذلك أن أحاول اكتشاف وجوه تبدِّيها الجديد، ومدى اختلافها، والإضافات التي توفرت عليها، لكني قبل ذلك كله كنت معنيَّا بالتثاقف معها من خلال تفهُّم تبدُّلات نسقها، ومن خلال سبر جمالياتها، سواء تلك التي تمثل تطورا لجمالياتها القارَّة منذ عقود مضت، أو تلك التي استجابت لشغف العوالم الرقمية وغواياتها والممكنات التي وفرتها، أو حتى للإكراهات التي فرضتها على المبدعين.
ولا أخفي أني كنت إلى جانب ذلك أحتفل بمتعة التلقِّي، وأوظف خبراتي ومعارفي كوني شاعرا وقارئا ومزاولا لوجوه مختلفة من الكتابة لصالح الاشتباك بالنصوص، ومساءلة وجوه تحققها.











